
| موضوعات عامة ويحتوي على مواضيع عامة متنوعة |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 | |||||||||||||
 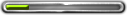
شكراً: 3,462
تم شكره 3,976 مرة في 2,568 مشاركة
|
إبتسمي يا قدس! قصة بقلم: د. نـبـيـه القــاسم للمرّة الثالثة أتسلّل من هذا الباب مُتحدّياً نظرات الحارس المُدجّج بالسلاح. أتخطّى العتبةَ العريضة، وأنسلّ بهدوء إلى الزقاقات المُظلمة باحثاً عنكِ، علّني أجدكِ في أحدها.. - هذه الزقاقات تشدّني إليها. أشعر فيها بالطمأنينة.. - لكنها مُخيفة في الليل.. - على العكس، فهي في الليل أكثر أماناً.. وحيدَين كنّا نسيرُ مُتحاشيَين النظرات المُتيقّظة، المبثوثة في كلّ منعطف.. - لا تتنفّس حتى لا يسمعوك.. وأشدُّ على يدكِ مُهدّئاً: - لا تخافي فأنا على حذر. للمرّة الثالثة أتسلّل ولا أجدك في طريقي. أفكّر بسؤال هذا الحارسِ علّه لمحك تمُرّين. لكنني أتذكّر كلماتك: - إيّاكَ وسؤالهم عنّي. إنّهم يكرهونني. هم يتحينون الفرص لقتلي. إيّاكَ. إيّاك.. الشارع الطويل المظلم يمتدُّ أمامي. وأنا أُتابع سيري علّني أجدكِ. تستقبلني نظرات الحارس الشامتة. يهزّ رأسَه مُحيياً بخبث. أودّ لو أستطيع تحطيم جمجمته.. - هكذا أنت دائماً تتسلّح بكلمة لو. أتمنّى لو أنّك تفعلُ مرة واحدة. حياتك كلّها عشتها وأنتَ تقول لو.. - لا تكوني قاسية في حكمِك. أنا واحد من المشلولين لكنّي سأحاول التمرّد.. - ولماذا تحاول أيها المشلول. إبقَ في روتينك. إبقَ سبّح باسم ربّكَ الذي خلقَ الانسان من علق. لا تُجهد نفسَكَ بالعمل.. - لماذا تعملين على قتلي، لماذا لا ترحمينني، كفى كفى.. أُسرعُ بخطايَ هارباً في شارع صلاح الدين.. - آه لو أنّك تعود يا صلاح الدين.. تتّسع خطواتي. أسمعُ وقع أقدام خلفي. أرتعد. أخاف النظر إلى الوراء. الأصوات تشتدّ ورائي. أجدّ في السّير. ووقع الأقدام خلفي يسرع ويعلو. أستجمع قواي وألتفتُ إلى الخلف. لا شيء. وحدي أنا في الشارع.. - لو أنّكِ معي. أينَ أنتِ الآن..؟ كان الشارع يقصر أمام خطواتنا ونحن نعبره في الليالي المُقمرة. فالقمرُ أجمل ما يكون في سماء القدس.. - أنظر إلى السماء. لقد اغتالوا القمرَ في سمائنا.. - لماذا أنتِ متشائمة إلى هذا الحدّ! فالقمرُ لا يزال هناك. والحبّ أكبر من كلّ عنفوان.. - كلاّ. لم يبقَ ما يُعرف بالحبّ في قلوبنا. لم يبقَ لنا غير الكراهية والحقد.. أجتاز شارع صلاح الدين في اتجاه شارع الأنبياء.. - الأنبياء! هؤلاء الذين حرمونا لذّة الحياة. حكموا علينا بالعذاب قبل ولادتنا، ولمّا وُلِدنا قيّدونا بقيودهم الظالمة.. أفتحُ باب غرفتي بحذر. علّك تكونين نائمة على السرير. أتحسّسُ زرّ الكهرباء. الضوء يملأ الغرفة. لا أحدَ على السّرير.. - أينَ أنتِ الآن. لماذا لم تجيئي..؟ حضّرتُ القهوةَ التي تُحبّينها. وضعتُ فنجانين على الصينيّة وجلستُ أنتظركِ. لا بدّ من حضورِكِ. فأنتِ حريصة على مواعيدكِ. - أنتَ مدعوّ للغداء عندنا ظهر يوم الجمعة غداً. إيّاك والتأخر أنا أكره الذين لا يحافظون على الوقت.. وابتعدتِ وأنتِ تلوّحينَ باصبعك. وضحك زميلي الذي كان يجلس قريباً منّي وقال مُعلّقاً: - يا بختَك. لستَ واحداً منهم.. ومطّ بشفتيه وابتعد ليُتابع عملَه بين الملفّات العديدة. - إذن فأنتَ لستَ منهم.. - كلاّ. أنا من الجليل. من بلاد الزيتون.. - وماذا تفعل هنا..؟ - أدرسُ في الجامعة.. - غريب. أيسمحونَ لكم بالدّراسة..؟ - ولمَ لا؟؟ - هكذا قيلَ لنا.. - يسمحون، ولكن.. - لا تُتمِّم كلامَك. أترك ولكن إلى وقت آخر. أنا أدعوك للغداء عندنا ظهر يوم الجمعة غداً.. البُرودة تتسرّب إلى غلاّية القهوة. وعقاربُ الساعة تتعانق لتعلن الثانية عشرة. منتصف الليل. وأنتِ لا تجيئين.. في الثانية عشرة تماماً. ظهر يوم الجمعة طرقتُ بابَ بيتكم. ويدُك الرقيقة امتدّت لتشدّ بي إلى الدّاخل، بينما تعالى صوتك منادية أمكِ: - أمّي تعالي تعرّفي على الضيف.. ومدّت أمّك يداً حذرةً، ونظرت إليّ بشكّ رهيب قائلة: - أهلا وسهلاً.. - إنّه من هناك يا أمي. من بلد الزيتون.. ولاحظت أمّك بذكائها الفطري أنّكِ تحاولين طمأنتها. فقالت بابتسامة مُسايرة بابتسامة اغتصبتها: - أنعِم وأكرِم.. عقاربُ الساعة تتباعدُ بعد تعانقها الحميم. ثم تنافرت بعد أن كانت تشدّ بعضها بعضاً. وأنا وحدي مع غلاّية القهوة التي تُحبّينها.. - لقد خرجت منذ الصباح يا ولدي ولم تعد.. وعدتُ للمرّة العشرين هذا اليوم لأسأل عنكِ. وللمرّة العشرين أسمع الكلمات نفسها. وفي كلّ مرّة ألمح بوادر دمعة تطفر من عيني أمّكِ.. - إنّها عنيدة يا ولدي. حاول اقناعها بعَبَث عملها. حاول. ليس لي غيرها. فكلّهم ذهبوا ولم يبقَ لي أحد.. وتضحكينَ ساخرة عندما أكلّمكِ. وتهزّين رأسَكِ، أن أصمت. وأصرخ في وجهكِ. - لا تصرخ هكذا. إنني أمقت الصراخ.. - ولكنّكِ لا تُجيبين. لماذا لا تتفهمينها. إنّها أمّكِ.. - لكنّها سخيفة كالآخرين.. - هي تحبّك وتريدُ لكِ الخير. فلماذا تُحطّمينَ قلبَها..؟ - وأنا أيضاً أحبّها. ولولا حبّها لما فعلت ما أفعل.. فوجئتُ عصر ذلك اليوم عندما سمعتُ صراخ أمّكِ وأنا أدخل بيتكم. كانت أمك تصرخ وتبكي، وأنتِ تجلسين إلى طاولتك تقرأين. أمسكتُ أمّك أحاول تهدئتها.. - أتركني يا ولدي. إنّها ستميتني. هذه البنت العاقّة ستُميتني. أكثر من مرّة قلتُ لها لا تذهبي إلى هناك. لكنّها تصرّ على الذهاب، لا أمل فيها، إنها ستوصلنا إلى القبر.. وانتفضتِ ساعتها، ورميتِ الكتابَ بعيداً، وحضنتِ أمّك وأنتِ تقولين: - معاذ الله يا أمي، فالقبر للآخرين، لكنني.. وصرخت أمّك: - لا تقولي لكنني، أنا أكره هذه الكلمة. لو كان أبوك على قيد الحياة لكانَ.. - نعم يا أمي لو كان أبي على قيد الحياة لَما فعلتُ ذلك لكنهم قتلوه، أتسمعين، قتلوه.. - ولماذا أنتِ التي تحملُ دمَ أبيها، لماذا لا تتركينَ ذلك لإخوته، ولأخوتكِ، لماذا لا تفعلين مثلهم..؟ - إنّهم تافهون يا أمي، خدعتهم النقود البرّاقة. والذين فكّروا مثلي قُذِفوا إلى السّجن أو إلى الصحراء حيثُ الذّل والعراء والجوع. القبرُ ليسَ لكِ يا أمي بل للآخرين.. استيقظت في السابعة على غير عادتي. تقلّبتُ في السّرير. استغربتُ منظري في المرآة المقابلة. لا أزال ألبس ثيابي. رفعتُ رجلي، فرأيتُ الحذاء في قدمي. اشتدّ عجبي. ولمّا حاولتُ مراجعة ما حدثَ لي أمس. وقعَ نظري على غلاّية القهوة والفناجين فتذكّرتُ كلّ شيء. أسرعتُ بالنهوض. غسلتُ وجهي على عجل. رشفتُ القهوة وخرجتُ إلى الشارع.. شارع يافا على غير عادته في مثل هذه الساعة. يعجّ بالناس. والسيّارات تزدحم عند تقاطع الطرقات. سيّارات الشرطة تجوبُ الشارع بسرعة جنونية. كلّ ما يُحيط بي يثير التساؤل. أتابع سيري. أريد أن أصل إلى بيتك علّني أجدك. يعلو صوت بائعي الصحف. وتخرج الحروف العبرية من أفواه الأطفال العرب الصغار مُضحكة. أكثر من طفل يتراكض في الشارع وهو يُدلّل على صحيفته التي يحملها. أيدي الكثيرين من المارّة تتسابق لتناول الصحف وأنا أتابع سيري، عند تقاطع طرق أضطرّ إلى الوقوف بسبب الإشارة الحمراء. أسمع لغط الواقفين إلى جانبي.. - هذا شيء مخيف. كيف يحدث هذا ..؟ ويردّ عليه الثاني: - لا شكّ أنّ في الأمر سرّاً خطيراً.. وتعلّقُ واحدة: - أصبح الخطر يتربّص بكلّ واحد هنا.. ويتدخل رابع: - ولكن كيف سأكون مطمئناً على أطفالي إذا عالجوا هذه الحادثة كغيرها.. وتغيّر اللّون الأحمر، وابتعدتُ عن كل الذين كانوا معي، ونسيتُ كلامهم. وماذا يهمّني الذي قالوه.. شيء واحد يُشغلني هو أنتِ. ليذهب الجميع إلى جهنّم. المهم أن أجدكِ أنتِ. النساء. الأطفال. الرجال. الشرطة، كلّ هذا لا يهمّني. أنتِ فقط، أنتِ التي تهمّني.. أُوقفُ أوّل سيارة أجرة أصادفها عند الباب الجديد.. - إلى وادي الجوز.. بحلق السائق بي وقال مُستغرباً: - آسف يا أستاذ. هذا غير معقول.. - لماذا؟ ماذا هناك..؟ - يظهر أنك لم تسمع بالخبر..! - أيّ خبر؟؟ - إنّ الشرطة تطوّق وادي الجوز منذ ساعات الصباح الأولى بسبب حادث القتل الذي جرى أمس في حيّ الجبشة. فتحتُ باب السيّارة. اندفعتُ بسرعة دون أن أسمع تتمّة حديث السائق. أخذت أركض في اتّجاه باب العمود. غلام في الرابعة عشرة من عمره كما يبدو من منظره يصيح بأعلى صوته: - جريدة الفجر مع ملحق خاص يروي تفاصيل الجبشة. تناولتُ الجريدة منه، وقبل أن أفتحها، شعرتُ بيد ثقيلة تُمسك بكتفي وتهزّه.. - ماذا تفعل هنا..؟ رفعتُ نظري عن الجريدة لأفاجأ بشرطي يُمسكُ بي وينتظر جوابي.. - ماذا تفعل هنا..؟ - ولماذا لا أكون هنا..؟ شدّ على أسنانه وقال بحزم: - هات هويتك. نظرَ إليها بتفحّص شديد ثم قال: - ماذا تفعل في القدس؟ - أدرس في الجامعة. - طيّب انصرف.. وانصرفتُ لألتجئ إلى أقرب مقهى. فتحتُ الجريدة وبدأتُ أقرأ وأنا لا أصدّق. (بُشرى عزّ الدين تقوم بعملية انتحارية ضد الغريب وموكبه في حيّ الجبشة انتقاماً لوالدها الذي قتله الغريب قبل خمس سنوات). ودوّى صوت انفجار رهيب.. ركضتُ إلى الخارج.. وقبل أن أستفسر، قال واحد: - هدموا البيت. ولفظني صلاح الدين من شارعه. وسرتُ هائماً في شارع الأنبياء. أريدُ أن أبصق على كلّ حجر أمامي. أريدُ أن أصرح بأعلى صوتي. أريد أن أعلن لكلّ مَن أصادفه. أنّ التي ماتت حبيبتي. وأنّ التي هدموا بيتها حبيبتي. عشرونَ عاماً ضيّعتها ولمّا وجدتها حرموني إيّاها. لو أستطيع أن أبصق في وجهك يا صلاح الدّين. لو أستطيع أن أزيلَ أسماءَكم يا أنبياء. حبيبتي تموت وأنا هنا أتسكّعُ في الشوارع. هائماً. ضائع الرقم والعنوان. عشرونَ عاماً وأنا أبحث عن ذاتي. ولمّا عرفتها سلبوني ذاتي.. عشرون عاماً مُنعتُ من الصّراخ حتى لا أزعج الجيران.. عشرون عاماً حُرّم علي البصق حتى لا ألوّث الأرض. حتّى البكاء حذّروني منه كي لا أثيرَ الآخرين. عشرون عاماً هي أحلى أيام عمري ضاعت هباء. شبحاً كنت بلا روح. جسماً بلا اسم. وإنساناً بلا عنوان. كنتُ أحاول التعرّفَ على نفسي فيسخر منّي الآخرون، وإذا سألتهم عن اسمي أجابوا: أنتَ لا اسم لك. هكذا عُرفتُ لدى الجميع. أنا الذي لا اسم لي. أنا الذي لا عنوان لي. أنا الذي لستُ أنا.. عشرون عاماً وأنا ألوبُ. ولمّا حقّقتُ ذاتي، وعرفتُ اسمي، وبنيتُ بيتي. حرموني حبيبتي.. كانت كالقطة التي سلبوها صغارها عندما سرتُ وإيّاها للمرة الأولى في شوارع القدس. رفضت أن نستقل سيّارة أجرة وفضّلت أن نقضي وقتنا في الطرقات هائمين. نتنشّق هواء القدس. اجتزنا متحف روكفلر في اتّجاه سينما القدس. مجموعة من الأطفال تتراكض تُدلّلُ على مبيعاتها. واحد تبدو الشيطنة الطفولية في عينيه المُبتسمتين يلوّح لنا بيديه قائلاً: - علكة يا خواجا، علكة.. أداعبُ خصلات شعره المُبعثرة بحبّ.. - لست خواجة يا شاطر.. عيناه المبتسمتان تتراجعان إلى الوراء. يده تتهاوى بخجل، ويُسرع بالابتعاد عنّا.. - هؤلاء الصغار، كم أحبّهم وكم أرثي لهم وأحسدهم.. لم أعلّق على كلماتها، ولم أحاول الوقوف على ما ترمي إليه. كانت بالنسبة إليّ لا تزال واحدة من اللواتي تعرّفتُ عليهن. أسبوع. شهر. ثم تضيع من حياتي. لم ألمح في عينيها رغبة في الوقوف أمام صور الفيلم الجديد المعروضة رفضت الدخول إلى السينما. ترغبُ في متابعة السير. لفّنا الظلام ثانية.. - أريد أن أرى القدسَ على حقيقتها. كرهتُ منظرَها المزيّف. دعنا نُتابع طريقنا.. سرتُ صامتاً إلى جانبها. أضرب الإسفلت بكعبِ حذائي، هذه الفتاة إلى أين تسوقني. عيون المارّة تتابعنا. تُعرّينا من ثيابنا. أحاولُ أن أكسر الصمت المطبق. ألتفتُ إلى السماء. أهمس بحركة تمثيلية: - ما أجمل القمر..! تغرزُ نظراتها الساخرة الحادّة بي. تضغط على يدي وتقول بحدّة مفتعلة: - لا تكن سخيفاً كالآخرين. أترك القمر في السماء وتكلّم عن الأرض. لا تُحلّق وراء الخيال وعِش الواقع. صمتُّ أواري خجلي.. هذه الفتاة الغريبة الأطوار ستُجننني. لماذا قبلتُ طلبها وزرتها في بيتها. ما معنى أن تدعوني واحدة للغذاء فأسرع لأطرق بابها. لو تراني الآن يا أبي وأنا أهيم في الشارع. لا أملك توجيه خطواتي. أنقادُ إلى فتاة لم يمض على تعرّفي عليها أسبوع واحد.. - لماذا أنتَ صامت؟ حدّثني عن نفسكَ، عن والدك العجوز. عن والدي! أيّة سخرية هذه. ماذا أقول عنه..؟ إنّه كان سيقطع رقبة أختي لو تجرّأت وسارت مع شاب كما تفعلين أنتِ الآن. إنه كان سيشتمني ويُعيدني ذليلاً إلى البيت لو عرف أنني أتسكّع معك في الطرقات. أم عن دموعه التي مسحها يوم سمع بزواج أخي الكبير من فتاة لم يرضَ عنها. ماذا أروي لكِ..؟ - لماذا لا تُجيب؟ حدّث.. - هل ترغبين في تناول فنجان قهوة في جروبي..؟ - لا. دعنا نسير. ما رأيك في اعتلاء السور ومراقبة القدس من فوق..؟ لم أمانع.. قطعنا الشارع العريض، واجتزنا مدخل باب العمود. التفتت إلى المتكوّم إلى جانب الآلة المدمّرة وبصقت على الأرض، فاعتقدَ أنّها تُحيّيه. هزّ رأسه متظاهراً بالطيبة وحيّاها بابتسامة عريضة. صعدنا الدرجات الحجرية، ووقفنا في أعلى السور.. كلّ العالم تحتنا. هؤلاء الأقوياء تحتنا. والسيّارات الناقلة للغرباء تحتنا. كلّ التفهاء. وكلّ الآخرين تحتنا. نحنُ هنا نُعانق التاريخ الطويل ونُطاولُ السماء. نتحدّى الحاضر ونرنو للمستقبل.. برودة الحجر الذي جلسنا عليه بدأت تتسرّب إلى أجسادنا، والريح الخفيفة التي بدأت تلفح وجوهنا طيّرت خصلات من شعرها الكستنائي الطويل وألقت بها على وجهي فاستقبلتها شفتاي بلهفة المحروم، وحنان العاشق. رفعت يدها لتعيد خصلات شعرها، فسبقتها يدي لتحضن يدها وتضغط عليها. لم تُقاوم كما أنّها لم تتجاوب. يدها كتلة من الصقيع. أدلّكها بأناملي. أمرّرها على وجهي. أقبّلها. ولا تقاوم. أرفع يدي الأخرى لأحضنها فتنفر. وتقفُ لتبدي رغبتها في السير. ترفض إلحاحي للجلوس أكثر. ننقل خطواتنا فوق السّور بصمت. لا نتبادل الكلام. ننـزل الدرجات الحجرية. تقترح أن نتجوّل في الزّقاقات المظلمة أوافق بتلهّف. نعبر الدرجات الأولى المؤدية إلى السوق، وعند أول منعطف تشدّني إلى جهة اليمين. الظّلام يخيّم على حيّ الجبشة. الأنوار المتباعدة المسترقة من بعض النوافذ العالية تذوب في بحر الظلام المُنتشر في الشارع الضيّق المُلتوي. الدرجات العريضة نجتازها بهدوء. وكلّما نتوغّل أكثر في الشارع، أشعر بيدها تزداد في ضغطها على يدي، وبجسدها يلتصق أكثر بجسدي. النيران تستعر في داخلي. أحيطها بذراعي فتزداد التصاقاً. خطواتنا تقصر. والدرجات العريضة تزدادُ اتّساعاً. فجأة نسمع مواء هرّة بالقرب منّا فتنتفض وتقول بحرارة: - إنّها رحمة.. وتقفز الهرّة لتتلقّاها ذراعا بُشرى بشوق. قبلاتها تتوالى على الهرّة. نيران الغيرة والغضب تجتاحني. أريد أن أرمي بهذه الهرّة بعيداً. أن أضغط على عنقها حتى تفارق الحياة. أحترق في أتون الغيرة ويدا بُشرى تُداعبان الهرّة وقبلاتها المتدفّقة تنهال على الهرّة بسخاء غريب. ضوء مفاجئ ينصبّ على جسم الهرّة الممتزج بصدر بُشرى من إحدى النوافذ المجاورة، فتقفز الهرّة وتختفي في السراديب المُظلمة القريبة. بشرى تئن بصوت مبحوح. تندفع للّحاق بالهرّة، أمسكتها بيدها. تئن بألم عميق: - حتى أنتِ يا رحمة تخافينهم؟؟ حتى أنتِ يُبعدونك عنّي؟؟ أشدّها إلى صدري مُهدّئاً، مستغرباً، فتلقي رأسها على كتفي وتطلب المعذرة. أداعبُ خصلات شعرها الكستنائي الطويل بيدي. أمرّر أناملي على شفتيها. أضغط على وجنتيها. ثمّ أدعهما لتضيعا في غابتها الكستنائية. أسألها عن الهرّة، فتقترح متابعة السير. نعبرُ المنعطفات المتوالية. وقبل أن نقطع المنعطف الأخير الذي يؤدي إلى مركز السّوق في حارة النصارى، وقفت وبحلقت في البناء الشامخ الذي ينتصب وسط الطريق. نظرتُ إليها مُستغرباً. ولمّا طلبتُ منها تفسيراً لذلك قالت: - غداً ستعرف كلّ شيء.. طال تحديقها بالبوابة المفتوحة الخالية. رغم العتمة المُسيطرة، لمحتُ دمعة تسقط من عينيها. شددتها وقلتُ راجياً: - دعينا نسير. إنّكِ غريبة الأطوار.. لم تُعلّق على كلامي. ولم تُمانع في السّير. هادئة سارت إلى جانبي. ولمّا وصلنا السوق لم أسألها عن المكان الذي ترغب في الذهاب إليه. مِلْتُ بها إلى اليمين في اتجاه الباب الجديد. وبالقرب من النوتردام وقفنا ننتظر عبور سيّارة أجرة لنقلنا إلى بيتها في وادي الجوز. أريد أن أعيدها إلى بيتها. لا أحتمل هذه التصرفات أكثر. نيران الغضب تتملّكني. تصرفاتها الغريبة تُفزعني. لا شكّ أنها تُعاني من لبس في عقلها. فما معنى أن تقترح صعود السّور ثم اجتياز الزقاقات المُظلمة. ومُعانقة هرّة ضالة واندفاعها وراءها في الظلام. ووقوفها أمام البيت الكبير. وبكائها الذي لا تفسير له. أريد الخلاص منها. إنّها تخيفني. أحاول جاهداً أن أبدو معها رقيقاً جداً. أرتّب لها رموش عينيها المُتباعدة. أفرك يديها بأصابعي. وأقول لأبعد الجوّ القاتم الذي ساد: - هل ترغبين في زيارة النوتردام غدا؟ هزّت رأسها ببطء وقالت بصوت مخنوق: - حلمت السنوات الطويلة بزيارته. لكنني الآن لا أرغب في ذلك.. وقبل أن أفتح فمي، وقفت سيّارة إلى جانبنا وأقلّتنا إلى وادي الجوز، ثم عادت بي إلى غرفتي في شارع الأنبياء. قرّرتُ أن أتركها. أن أخرجها من حياتي. هذه الفتاة الغريبة الأطوار لا يمكنني البقاء معها. عدتُ لأتابع حياتي العاديّة. ساعات الصباح أجلس خلف المكتب أستقبل أفواج القادمين لحلّ قضاياهم المتعلّقة بالوزارة التي أعمل فيها. وساعات بعد الظهر أقضيها بين أروقة الجامعة. أتابع محاضرات الأساتذة في موضوع التاريخ، وعندما أشعر بالملل أدخل إلى الكافيتيريا لاحتساء فنجان من القهوة أو لتبادل الأحاديث المختلفة مع بعض الأصدقاء.. اعتقدتُ أنّ حياتي هذه الهادئة ستُبعد عنّي طيف بُشرى وأنّ مُطاردة بعض الفتيات ستُنسيني ذكراها. لكن الذي حدث أنّها كانت معي كلّ المدّة التي ابتعدت بها عنها. كلماتها القوية الثاقبة. وجهها الحالم المتمرّد. دمعتها المنسكبة على وجنتيها. تُطاردني في كلّ لحظة أخلو فيها إلى نفسي وتدفعني للرجوع إليها للبحث عن الكنـز العجيب. للابحار في المحيط الغريب. عبثاً أحاول الهرب فهي أقوى منّي. تُقيّدني. تُفاجئني في كلّ مكان أكون فيه. تتحدّاني. تتّهمني بكلماتها القاسية.. - جبان. أنتَ جبان. في المكتب تتخطّى كلّ الواقفين في الصف وتقول لي: جبان. في الباص تُبحلق بي وتناديني: إلى أين تهرب يا جبان. على مقعد الدراسة تشدّ بوجهي إليها وتهمس على مسمع كلّ المجاورين: جبان. في الكافيتيريا تدخل عليّ وسط الزملاء المتجمهرين وتصرخ على مسامعهم: جبان. حتى في الليل تدفع بباب غرفتي بقوّة وتقول: جبان. جبان. كلمتها الأخيرة التي بصقتها بوجهي ساعة ودّعتها أمام باب بيتها. جبان أنا لأنني أظهرتُ لها تخوّفي من أطوارها الغريبة التي لاحظتها تلك الليلة. جبان لأنني لم أحاول التعرّف على "رحمة" الهرّة التي سرقتها من أحضاني أو السؤال عن ذلك البيت الكبير الذي ينتصب وسط الطريق في حيّ الجبشة.. جبان أنا. أعترف بجبني. جبان أنا لأنني حاولتُ الهرب من بُشرى دون التعرّف عليها. جبان لأنني أرغم نفسي على نسيان بُشرى. بينما هي معي في كلّ لحظة من لحظات عمري الحاضرة.. انهار جدار الخوف، وذاب جبل التردّد. المُقاومة ضعفت. والصّوت القوي الثاقب يهتف بي: - تعال.. الطريق إلى وادي الجوز تشدّ بي هاتفة: - تعال.. أنا في طريقي إلى هناك. انهارت مقاومتي. أنا بركان من الشوق.. أنا ضائع أبحث عن عنواني. شعور دفين يشدّ بي إلى هناك. كلماتها القوية الثاقبة. وجهها الحالم المتمرّد. دمعتها المنسكبة على وجنتيها. يدها المتشبثة بيدي في ظلام الجبشة. نظراتها الحزينة المعانقة لجدران النوتردام. كلّ هذه تصرخ بي: - تعال.. أدفع الباب بثقة أنني سأجدها بانتظاري.. - أنا بانتظارك غداً في الثالثة.. هكذا قالت لي ساعة ودّعتها في تلك الليلة. وها أنا أجيء في الموعد. لا بدّ وأنّها في انتظاري. لكنني فوجئتُ بصراخ أمّها الباكية، واتهاماتها لها بأنها ستوصلها إلى المنتهى. وفوجئتُ أكثر عندما سمعتها تولول في حضن أمّها. أنّهم قتلوا أباها.. ليلتها لم أقترح عليها مشاهدة الفيلم الجديد أو احتساء فنجان قهوة في الجندول. لم أنظر إلى السماء. ولم أتغزّل بالقمر بكلام ممجوج. سرتُ حاضناً ذراعها بصمت. لم نتفرّس في وجوه المارّين، ولم نُعِر تعليقات المُتسكعين على جانبي الطريق انتباهنا. نعبر الشوارع المتتالية بهدوء لم نتّفق عليه. كل واحد يعرف ما يريد الآخر منه وكلّ واحد يعرف المكان الذي يُريده.. في أعلى السور جلسنا متجاورين. يدي الواحدة تلفّ خصرها. والأخرى تداعب خصلات شعرها الكستنائي. نرقب الشارع الممتد تحتنا. نرقب الشارع الممتد تحتنا. ونُتابع السيارات الهادرة المتتالية فوقه. نظرتُ إليها بعد فترة صمت وقلت: - بُشرى، لماذا لم تخبريني بكلّ ذلك؟؟ لماذا كتمتِ سرّك هذا عني؟؟ رفعَت نظرها إليّ وقالت بحزن: - ولماذا أخبرك؟ وما معنى أن أشركك في حزني ومأساتي..!! شددتُ وسطها وقلت: - لكن حزنك حزني ومأساتك مأساتي. كيف يقتلونَ أباك وبأيّ حق فعلوا ذلك. أنا لا أفهم.. ابتسمت بألم وقالت: - كيف قتلوه؟ برصاصة رشّاش. قويّة. بأيّ حق؟ حقّ القوة. هل فهمت؟؟ - ولكن لماذا. لماذا أبوكِ بالذّات؟؟ - لأنه الوحيد الذي استهدفوه. الوحيد الذي اعتقدوا أنّ موته يوفّر لهم الطمأنينة. والوحيد الذي تحدّى وقال: لا. فقتلوه. قتلوه باسم الحقّ الذي قتلوا به آلاف الآباء والأبناء. عندما جاءوا ليُطالبوا أبي بإعادة البيت الذي يملكه عن أبيه بحجّة أنّه بيتهم المهجور. سخرَ أبي منهم ورفض سماع كلامهم. وإذ عادوا قصد إخراجه من البيت. تحدّاهم. وعندها قتلوه. هكذا وبكلّ صفاقة وأمام عيوننا وعيون كلّ الناس. قتلوه. قلتُ بألم: - كم أحسدكِ على والدك. قالت باستغراب: - ماذا تعني؟ قلت: - كنت أتمنى لو كان والدي كذلك. ورويتُ لها قصّة والدي الذي خدعوه وعلّلوه بالآمال، فترك للغير القيام بالواجب. واكتفى بتحدّي العالم يوم أُلقيت القنبلة الذريّة على مدينة هيروشيما اليابانية باغتصاب أمّي، ثمّ اغتصابه الثاني لها يوم حدث الزلزال الكبير بعد ثلاث سنوات. وكيف بسخافته اعتقد أنّه بعمله هذا يقوم بملحمة بطوليّة تُسجّل له. لكن الذي حدث أنّ أمي عندما استيقظت من غيبوبتها السمردية وأدركت واقعها الجديد انتحرت. وتركتني أبحث عن الثدي الذي امتصّ حليبه بقواي الذاتية رغم ذلّ اليتم والحرمان وقسوة الأهل والغرباء. من ليلتها أصبحت بُشرى بالنسبة لي شيئاً آخر. وجدتُ فيها أمي التي انتحرت، تعود بكلّ حيويتها وطيبتها وبراءتها. وحبيبتي الصغيرة التي حدّثني عنها والدي، وقال إنها اختفت يوم موت أمي. وبيتي الجميل الرائع الذي حلمت به طوال سنوات غربتي العشرين.. كنتُ أقضي كل ساعات فراغي معها. كرهتُ المكتب لأنه يبعدني عنها بعض الساعات. ومللتُ الدروس لأنها تبعدني عن التفكير بها. منذ تلك الليلة تغيّرت بشرى. لم تعد تلك الفتاة الحادة الغاضبة القويّة. أصبحت ضاحكة تحبّ الغناء. وتحمّسني على دخول السينما وحضور حلقات الرقص. وإذا ما جمعتنا جدران غرفتي أو بيتها، تُسرع لتُدير المسجّل على أغنية فيروز (سوف أحيا).. أذكر كلماتها جيداً يوم سألتها عن سرّ حبّها لهذه الأغنية بالذّات: - إنّها تروي قصتي مع الحياة. فأنا الوردة التي لن تعيش طويلاً.. ولمّا حاولت مناقشتها في سخافة تفكيرها، قالت بحزمها القديم: - أرجوك. هذا ما أنا واثقة به. فلماذا تُحاول المستحيل.. كان الموت موضوعها المحبّب. دائماً تناقشني فيه وتلحّ علي في زيادة التفاصيل عن الحياة الأخرى.. - حدّثني أكثر عن رأيك في الموت. عن الرّوح المتقمّصة الخالدة التي تؤمن بها.. ويزداد حماسها كلّما حلّلتُ لها هذه النظرية. وتهمس في شبه غيبوبة: - إذن، فأنا لن أموت. أنا سأعود إلى الحياة ثانية. بصورة جديدة. واسم جديد. وعنفوان أكبر.. وأضمّها إلى صدري، وأحاول تهدئتها قائلاً: - أجل يا حبيبتي لن تموتي. فأنتِ خالدة.. كانت تخاف الموت قبل أن ترى القدس على صورتها الضاحكة الباسمة.. تُلقي رأسها على كتفي وتُجيب بهمس: - أمنيتي في الحياة أن أرى القدس تبتسم.. وأشدّها إلي وسط الظلام المُحيط قائلاً: - حقاً إنّ القدس ستبتسم يوماً.. وساد بيننا صمت. كانت أناملي تغوص في غابتها الكستنائية وأنفاسها الدافئة العطرة تعبق في عنقي.. - أتعرف، أنني أصبحتُ أحب الموت؟؟ أجبتها باستغراب: - لماذا..؟ قالت: - لأنّه لم يعد يعني النهاية بالنسبة لي، إنّما رحلة انتقال. أجبتها قصدَ تغيير موضوع الحديث: - لكنني لا أريدك أن تقومي بهذه الرحلة، أريدك معي هنا.. شددتها إلى صدري. لكنّ صوتها الحالم الرقيق انساب مُرتّلاً: - معكَ سأبقى. لن أتركك.. قد أغيّر صورتي أو أبدّل اسمي.. لكنني سأظلّ لك.. وأجبتها منفعلاً: - لكنني أحببتُ صورتك هذه. واسمك هذا.. ضغطت على يدي وقالت: - وستحبّني على صورتي الأخرى. وباسمي الثاني. ماذا تهمّ الصورة؟؟ وماذا سيتغيّر إذا كان اسمي بشرى أو عائشة أو رجاء. أو حتى منتهى. - ولكنني عرفتك أنتِ وأحببتكِ أنتِ.. - وستعرفني باسمي الآخر، وستحبّني باسمي الآخر.. - والقدس التي عرّفتني بكِ، وجمعتني معكِ، وحبّبتني فيكِ أينَ سأجد مثل القدس؟؟ وكيف سأرضى بغيرها..؟ - هل هي أيضاً متجدّدة مثلي. خالدة مثلي.. وصرختُ بألم: - لكنها لا ترضى بتغيير اسمها وصورتها.. قالت بهدوء: - لأنها القدس. فالأم واحدة. ولا يمكن للواحد منّا أن تكون له أكثر من أمّ في وقت واحد.. قلت: - ولماذا أنتِ وحدكِ التي تحملين هذه الآراء..؟ قالت: - لأنني عرفتُكَ وأحببتُ معك القدس. قلت: - وهل هذا يقضي باعتناق هذه الآراء..؟ قالت: - حتى تبقى القدس باسمةً، وحبّنا خالداً. * * * لم أدخل حيّ الجبشة منذ ذلك اليوم الذي فقدتُ فيه بُشرى. ليس لأنني رغبتُ في ذلك، بل لأنّ الغريب سدّ الطريق المؤدية إلى الحي، وفرض شرط الحيازة على إشارات العبور على كلّ راغب في دخول الحي.. ولأنني لست من الذين يُسمح لهم بطلب هذه الاشارات فقد حُرمتُ من دخول الجبشة.. أكثر من مرّة حاولتُ التسرّق كشأني مع بُشرى. لكنني كنت أُكتَشَف في كلّ مرّة وأُحذّر.. حتى السور حُرّم عليّ لأنه كما قيل يُطلّ على حيّ الجبشة.. لكن ما أسعدني قبل يومين خبر قرأته في جريدة الصباح يقول: "إنّ الغريب قرّر بناء سور مرتفع حول داره الكبيرة، وذلك لأنّه رأى في منامه مخلوقاً مخيفاً يتسلّل إليه في مخدعه برفقة هرّة قصدَ اغتياله". وتعلّق الصحيفة قائلة: "إنّ أهالي الجبشة قابلوا الخبر بالابتسامات العريضة".. . ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك المصدر: منتديات حبة البركة - من قسم: موضوعات عامة |
|||||||||||||

|
| 2 أعضاء قالوا شكراً لـ مونمون على المشاركة المفيدة: |
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
 مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا
في الموقع .. اضغط هنا للتسجيل
.. ولتمتلك بعدها المزايا الكاملة, وتسعدنا بوجودك
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا
في الموقع .. اضغط هنا للتسجيل
.. ولتمتلك بعدها المزايا الكاملة, وتسعدنا بوجودك
الساعة الآن 10:37 AM.





 العرض العادي
العرض العادي

